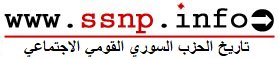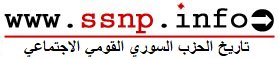للأحزاب تاريخ في الذاكرة البشريّة، منذ نشوء الحضارات كما نعرفها في الرحم ما بين النهرين وبعدها في انتشار الجذوة المدنيّة من قرطاجة إلى أثينا وروما إلى انفتاح الزمن، آخذين في الإعتبار تنوّع مفهوم "الحزب" بين الحضارات والثقافات والتجارب وتطوّره عبر المراحل.
وإذا كان موضوع "الحزب" فكرةً وآليّة ونسيجًا دار في بعض البؤر البشريّة مدار العصبيّات الأوّليّة كالعائليّة، فإنّه في بؤر إجتماعيّة أخرى تقدّمت فيها مصالح الحياة إتّخذ من الروابط الإقتصاديّة – الإجتماعيّة جامعًا له وموضوعًا.
ففي أوروك، المدينة السومريّة، ظهرت أوّل عمليّة سياسيّة من ثنائيّة حزبين اتّخذا إطار مجلسين: "مجلس شيوخ" و"مجلس محاربين"، فكان السّنّ حاسمًا بما يحمله تقليديًّا من اختلاف في الثراء والمُلكيّات كما وفي الشخصيّات من تروِّ أو اندفاع، خوف أو شجاعة، قناعة أو طموح. ولجلجامش ملك أوروك الصاعدة في تصدّيه لآجا ملك المدينة السومريّة الأقوى كيش باع في المناورة السّياسيّة بين المجلسين/الحزبين للإستحصال على تأييد لقراره بالحرب وعدم الإستسلام[1].
وأمّا المنافسة السياسيّة – الإقتصاديّة بين ملاّكي أراضي قرطاجة وتجّارها البحريِّين، وموقف الجهتين المتفاوت من مسألة الحرب والسلم مع روما فمن شواهد الحراك السّياسيّ الرفيع.
وأمّا في الصحراء العربيّة، فأدان المنطق القرآنيّ الناشئ الأحزابَ/القبائلَ المتحالفة ضدّ محمّد ودعا، من منطق الإله الأحد، إلى حزب واحد هو حزب الله في مواجهة حزب الشيطان، ممّا أطلق في العربة أوّل محاولة للإرتقاء بمفهوم الحزب من الجزء المفتِّت إلى الكلّ الجامع ومن رابطة الدّم - التعصّب إلى رابطة الفكر – الإيمان.
غير أنّ إسقاط ما جاز في الجزيرة العربيّة منذ أكثر من 1300 عام على مشرقنا وزماننا، واستغلال منطق "ومن يتولًّ الله ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون"[2] في غير موقعه الحضاريّ والسياسيّ والإجتماعيّ، فليس إلاّ بعضَ الصراع بين التعددّيّة الحزبيّة الحقّة ومحاولة الإستئثار الطائفيّ المستقوي بسلطة إفتراضيّة أعلى!
وإذ أطبقت قبضة المغول على آماد آسيا الحضاريّة، تفجَّر المخزونَين العلميّ والفلسفيّ السوراقيّ والمغربيّ والفارسيّ والصينيّ والهنديّ في نهضة أوروبا، المحطّة الجديدة في رحلة الحضارات البشريّة، وأثمرا في ثوراتها العلميّة والمفهوميّة والصناعيّة، ممّا مهّد لمتغيّراتٍ جمّة في الربع الأخير من الألفيّة الثانية طبعت العالم بأسره بِسِماتٍ جديدة، ومن ضمنها دور "الحزب" في الإجتماع والسياسة.
ففي القارّة الجزيرة، أيقنَت العائلات القويّة الغنيّة من مستوطنيّ أميركا الشماليّة بعد معاهدة السلام مع بريطانيا في العام 1783 أنّ المواد القانونيّة للكونفدراليّة المتبنّاة في العام 1777 لا تضمن الحفاظ على إتّحاد الولايات، إذ أنّ الكونغرس حتّى ذلك الحين لم يكن أكثر من مجلس سفراء للولايات، يَقترح ولا يُلزِم، شرَع ممثّلوها في صياغة شكل سياسيّ قانونيّ جديد يعطي الكونغرسَ قوّة الإلزام للولايات. ومن تباين وجهات النظر في مدى صلاحيّة الكونغرس وحدود العلاقة بين الولايات بذاتها وبينها متّحدة، نشأت الحزبيّة الأميركيّة[3] بدءًا من الحزب الديمقراطيّ الجمهوريّ برئاسة توماس جيفرسون في العام 1792 مرورًا في مطالع القرن 19 بالـ Whig Party حين تركّزت مواضيع الخلاف الأساسيّة بينهما على الشؤون الماليّة كبنك الولايات المتّحدة والتعرفة الجمركيّة.
وإن جدَّدت "الثورة" الأميركيّة الميكانيزم الحزبيّ كمبنى للديمقراطيّة التمثيليّة ولتداول السلطة سلميًّا، فإنّ حزبيّتها ظلّت محدودة في خياراتها الفلسفيّة الإقتصاديّة والسياسيّة، في حين ضخّت أوروبا المعنى في فكرة الأحزاب. إذ، وبسبب حركتها الحضاريّة المتأصّلة فيها والمتغيّرة وتاريخها الغنيّ وتفاعلها بالحضارات المحيطة بها، قدّمت الأحزاب الأوروبّيّة خيارات حقيقيّة في العقائد والبرامج، ولأيّ ناظر اليوم أن يرى الفرق بين تشابه حزبَيّ الولايات المتّحدة الديمقراطيّ والجمهوريّ حتّى التوأمة من جهة، وقوس قزح الأحزاب من شيوعيّة وإشتراكيّة وليبراليّة وقوميّة وديمقراطيّة مسيحيّة وإجتماعيّة ديمقراطيّة وبيئيّة إلى غيرها في أيّ دولة أوروبّيّة.
وأمّا في مشرقنا المحتلّ عثمانيًّا، فقد لعبت الجمعيّات السّياسيّة والأحزاب دورًا طليعيًّا لم يكن معنيًّا بتداول السلطة بقدر ما كان مهتمًّا بالنهضة والثورة للتحرّر والتحرير! ولعلّ هذه الهويّة الجنينيّة للـ"حزب" طبعت منطقه ولازمته حتّى بعد تفكّك الإمبراطوريّة العثمانيّة وسيطرةِ الإحتلالين البريطانيّ والفرنسيّ على المشرق وثمّ انسحابهما بعد أن أسّسا دويلات اتّفاقيّة سايكس – بيكو. فبُنية الـ"الحزب" وروحيّته الدائرتَان على محور مجابهة العدوّ المحتلّ إنتقلتا بعد الإستقلالات لتنصبّا على الأحزاب الأخرى نظرةً قتاليّة إلغائيّة وتكفيريّة!
2
من جماليّات "الحزب"، أيّ حزب في العالم، أن يجتمع أفراد من خلفيّات تربويّة ومناطقيّة واقتصاديّة وعلميّة ودِينيّة في مؤسّسة واحدة هي مصغَّر الدّولة، وفي آن هي المجتمع مكثَّفًا!
ومن جماليّاته أنّه نطاق الفعل السياسيّ الراقيّ الحديث: فكرًا وممارسة ومحاسبة ومراجعة ونموًّا وبرامج ومواقف وقراءات ومشاهدات وإبداعات.
ومن جماليّاته، أنّه إنسانيّ عقلانيّ بامتياز!
ومن جماليّاته، أنّ الفرد فيه يلتزم المجموعة إراديًّا. فإذا كانت الهويّات القوميّة والعائليّة والجنسيّة (ذكرًا أو أنثى) والخريطة الجينيّة هي ممّا لا خيار للأفراد فيه، فإنّ الـ"حزب" هو أهمّ هويّة سياسيّة إجتماعيّة يختارها الفرد حرًّا: حرّ بنسبيّةٍ، نعم، هي مزيج بين الثقافة والتربية والقدرة الذاتيّة ونبض العقل! حرّ بنسبيّةٍ، نعم، هي تفاعل الأسئلة بالأجوبة والفكرة بالجمرة والحلم بالسيرورة؛ حرّ بنسبيّةٍ، نعم، ولكن حرّ!
وإن قبِلْنا فكرة تحديد ماهيّة النظام الحيّ بيولوجيًّا بأنّه ثالوث النمط والبنية والعمليّة[4]، فـ"الحزب" سياسيًّا وثقافيًّا وبهذا المعنى حيّ وحيّ وحيّ!
وأمّا موته، فهو، كأيّ جسم حيّ آخر، بخرق شروط الحياة، كألاّ يتفاعل مع المحيط أو أن يفسد تفاعلُه مع المحيط تنظيمَه الذاتيّ؛
أو كأن يعتمد في طاقته على المصادر الفاسدة أو ألاّ يلفظ من ذاته ما فَسُد فيه؛
أو كأن يتوقّف فيه فعل الإدراك وتتجمّد حركة وعيه أو تتبخّر!
أقول من جماليّات الـ"حزب"، ولا أعني إلاّ حزب الفكر/المبادئ/البرنامج، أمّا حزب القبيلة/العائلة/المنطقة/الطائفة/الدِّين فهو وبحسب التوقيت العالميّ للبشريّة ساعةٌ من رمل!
3
حفِل القرن الأخير في المشرق بفترتين واضحتَيّ المعالم بما له علاقة بالأحزاب: في المرحلة الأولى وفي النصف الأوّل من القرن الماضي نشأت أحزاب عقائديّة وتحديدًا الحزب الشيوعيّ والحزب السّوريّ القوميّ الإجتماعيّ وحزب البعث العربيّ الإشتراكيّ (بعد اندماج شقّيه)، وانتشرت كالهواء في الفراغ بالرغم من صلابة معاندة المؤسّسات الإجتماعيّة والسّياسيّة التقليديّة المسيطرة وتحجّرها، واستقطبت الأحزابُ الجديدة المواطنين مخترقةً الطوائف والطبقات والعائلات والمناطق. ولأنّ هذه الأحزاب تنتمي في بنيتها إلى العصريّة السياسيّة ولأنّها في فلسفاتها ومواضيعها وقضاياها مراجلُ تفكيرٍ وحراكِ ومصانعُ أفرادٍ نقديّين وتنظيماتٍ إجتماعيّة حديثة، سارعت الطوائفُ والإقطاع العائليّ في لبنان خاصّة إلى تأسيس أحزابها لتضمن حضورها في القيامة الإجتماعيّة الجديدة، وإن بصفة مُخادع! تتظاهر بالتجدّد بينما تُبقي الدواخل على حالها. هكذا، سجّلت الطوائف أوّلَ عمليّات السيليكون والبوتوكس التجميليّة قبل أن هذه تكون!
وبالرغم من أنّ تعريف الحزب في المنجد هو "جماعة من الناس"، وكذلك هو تعريف الطائفة، فإنّ التناقض بين فكرة "الحزب" العصريّ وبُنْية الطائفة التقليديّة كانت جليّة:
فالـ"حزب" اقتناعٌ فاعتناق وأمّا الطائفة فتوريثٌ وأختام.
والـ"حزب" مساءلةٌ دائمة وأمّا الطائفة فتسليمٌ بأجوبة.
والـ"حزب" برَسم الجديد وأمّا الطائفة فنهايات وخواتيم.
والـ"حزب" برّانيّ منفتح وأمّا الطائفة فجوّانيّة منغلقة.
والـ"حزب" نهر شلاّل، وأمّا الطائفة فركودُ مستنقع!
والـ"حزب" تسليحُ المواطن بالمسؤوليّة وتفعيله في الدولة، وأمّا الطائفة برعاتها ورعيّتها والمراعي فتجميع نِعاج! نِعاج إنّما بمخالب وأنياب!
ولكن، وبعد احتلال الإسكندرون وكيليكية والأهواز وفلسطين والآن العراق، والحروب التي تلتها ولمّا تنتهي مع الأعداء المحتلّين، وبعد اقتتالَين في لبنان، وانقلابات لا تُحصى في الشام والعراق، وبعد أن ناضلت الأحزاب وصارعت واستشهد مؤسِّسو بعضها وعشرات الآلاف من أعضائها ومسؤوليها في الصراع لأجل الحقّ والحقوق، وبعد أن أشعل مؤسّسوها والكثير من مناضليها بالفكر الوقّاد والأجساد الملتهبة ما ينير للعبور "من كهوف الشرق، من مستنقع الشرق، إلى الشرق الجديد"[5]، بعد كلّ هذا، دخلت الأحزاب العقائديّة تدريجيًّا في المرحلة الثانية لأسباب متعدِّدة لا مجال لتفصيلها هنا، حيث فقدَتْ ملكةَ الجذبِ والفاعليّة والضوء.
وإنْ نجحت الطوائف في المرحلة الأولى في تسخير شكل "الحزب" العصريّ لمضمونها البدائيّ التقليديّ الجامد، إبتلت فعلاً الأحزابُ العقائديّة في المرحلة الثانية بمضمون التطيّف: فكرٌ صنم؛ ترديدُ كليشيهات؛ أوهامٌ بالتفوّق؛ خضوعٌ تام لسائس الطائفة وتبرير الفساد الداخليّ؛ فوبيا المختلِف؛ الشكّ؛ طقوس طقوس طقوس؛ سيطرة ثقافة الإشاعة والشفهيّة وما خفّ!
وأكثر!
فيما بدّدت الأحزاب العقائديّة الوقت في مقاربة الهويّة ووعيها، قوميًّا أو طبقيًّا، بالوعظ والمجادلات المطّاطة والتجريد المفرط واكتفتْ، كانت الطوائف المتحزِّبة تُشكِّل هويّةَ المواطن الطائفيّة فعليًّا يوميًّا من دورة علاقات حياتيّة طائفيّة مُحكَمة الإقفال: إضافة إلى استغلال آحادِها وجُمَعِها سياسيًّا وإعلاميًّا، أنشأت الطوائفُ المؤسّساتِ التربويّة والإقتصاديّة والسياسيّة والإجتماعيّة والإعلاميّة البروباغانديّة، من مدارس وجامعات وفرق كشفيّة ورياضيّة وجمعيّات نسائيّة وشبابيّة وتلفزيونات وإذاعات وصحف ومجلاّت ومجمّعات سكنيّة ومصالح مهنيّة وحتّى وزارات خارجيّة. من المهد إلى اللحد، تقبض الطوائف على الوقت!
إنتهت الألفيّة الثانية على طوائف متحزِّبة ولا حزبًا عصريًّا واحدًا!
وليس صدفة! أن ينتهي القرن العشرين بوحيد قرن عالميّ لا يتعامل مع شعوب الأرض قاطبة إلاّ أعراقًا وطوائف وإثنيّات.
وليس صدفة! أن وحيد القرن العالميّ هيّأ بسياساته على مدى عقود لأجواء تنتج طوائف متحزّبة وأعراق متحزّبة. وليس تدمير العراق وكلّ ما يعني وحدته الإجتماعيّة والسياسيّة كَنهب تراثه السومريّ البابليّ الأكاديّ الآشوريّ المحفوظ في المتاحف إلاّ توقيع وحيد القرن على إبادة إرث العراق الجامع، كي تلجأ الطوائف إلى سِيَرها وانعزالاتها فيسهل على وحيد القرن أن يفترس!
ولم يكن لبنان خاصّة منذ الطائف خارج مرمى نظر وحيد القرن الأميركيّ! وكلّ الدلائل أنّ الإفتراس ابتدا!
4
... وحرّ بنسبيّةٍ. نعم.
فأساليب السيطرة على الأفراد من وجهة نظر علم الإجتماع السّياسيّ، تتجلّى وفق أسلوبين:
"هناك أوّلاً تنظيمات خارجيّة، أي مجموعة قواعد إلزاميّة، يدركها ذاتيًّا الخاضعون لها باعتبارها تفرض نفسها عليهم من خارج إرادتهم. وهي يمكن أن تكون ذات طابع قانوني، كالقوانين والقرارات التنظيميّة المكوِّنة أحيانًا لأنظمة قانونيّة حقيقيّة، بمعنى أنّها تنظّم مجموعة متماسكة ومترابطة من الحقوق والواجبات، كنظام الوظيفة العامّة. ويمكن أيضًا أن تكون ذات طابع إجتماعيّ – ثقافيّ، كالعادات وقواعد السلوك واللغات والقيَم والمعتقدات، ألخ.
وتوجد ثانيًا تنظيمات داخليّة، وهي تنجم عن سيرورة نفسيّة إجتماعيّة نشيطة، يجريها الفرد، وتكمن في استبطان الإكراهات الخارجيّة التي يصطدم بها، بمعنى أنّه يجعلها إكراهاته... يصل الفرد الذي يتبنّى الأوامر الإجتماعيّة التي لا يمكن تفاديها إلى أن يعيشها وكأنّها منبثقة من وجوده الداخليّ، وضميره الحميم. إنّه يضفي طابعًا شرعيًّا على طاعته (الإضطراريّة) إمّا أخلاقيًّا بإسم النزعة المدنيّة أو القواعد الأخلاقيّة، وإمّا عقلانيًّا بإسم الأنظمة الضروريّة للحياة في المجتمع. وتسمح سيرورة الإستبطان بالإنصياع من دون انحطاط لأن الفرد يكون لديه إنطباع بأنّه لم يعد يطيع إلاّ نفسه."[6]
وهنا بيت القصيد: "في استبطان الإكراهات الخارجيّة" و"انطباع (الفرد) بأنّه لم يعد يطيع إلاّ نفسه" يكمن همبابا[7] الطوائف!
إذ تولد الطفولة في بلادنا خاليةً من HIV الطائفيّة، سرعان ما يتمّ حقن دمها بالإيدز الطائفيّ، ثمّ حقن إكسسواراتها فأعيادها فلغتها فعقلها:
في المدرسة ألِف إذ يُسمَح للمولودين مسلمين من الأطفال بأن يلعبوا بينما يخضع المولودون مسيحيّين لصفّ دِين! والعكس في المدرسة باء.
وفي المدرسة جِيم إذ يُطلَب من التلامذة المولودين موارنة وكاثوليكًا حفظ "قانون الإيمان" بينما يُعفى المولودون أرثودوكسًا وآخرون من هذا الواجب؛
وفي الوظائف، ومن أجل استثمار ما أمكن من جهد الموظّفين، يأمر "أرباب" العمل والمدراء موظّفيهم المولودين مسيحيّين بالحضور إلى العمل كالمعتاد في الأعياد ذات الطابع الإسلاميّ، والعكس!
أولئك المجرمون!
وفي السياسة، ولغايات إنتهازيّة فرديّة، قراراتٌ تُمعِن في الفسيفساء. ومن أمثلة الحضيض قرار وزير عملٍ سابق لحزب علمانيّ عقائديّ بعطلةٍ يوم الجمعة للتجّار بالرغم من أنّ لبنان الإقتصاديّ والتجاريّ يستريح يوم الأحد. وبعد الإعتراضات والإستهجان، تبرير الوزير السابق لفعلته بأنّ قراره يشمل تجّار صيدا وليس تجّار مغدوشة! هكذا من دون زيادة أو نقصان! من حزب علمانيّ إلى حزبٍ مغَذٍّ لطائفيّةِ المدن والقرى! فما سحَب الحزبُ وزيرَه؛ وما أقاله؛ وما حاكمه؛ وما انتفض الأعضاء على المعبِّر عنهم زورًا في الحكومة اللبنانيّة وما اهتمّوا؛ بل لعلّهم ما فطنوا لارتطامات السقوط!
وأولئك المجرمون!
إذا كان لقلّةٍ من أطفال بلادنا ومراهقيها ما لِصوفي أموندسن Sophie Amundsen[8] التلميذة المراهقة من حظِّ رعاية فكريّة ونعيم الإستمتاع برحلة فلسفيّة عبر الأزمنة مع مرشد واعٍ، فلَيس لأكثرهم إلاّ حِقَن الإيدز الطائفيّة مع كلّ نفَس، حتّى إذا ما نما المواطن ورشُد وقرّر العمل السياسيّ، جهُز مثالاً لـِ"استبطان الإكراهات الخارجيّة" و"اختار" مرغَمًا حزبَه الطائفيّ مأمورًا منقادًا منصاعًا.
5
يفتخر الكثير من اللبنانيّين، من مثقّفين وناشطين صادقين وسياسيّين ويساريّين جدد ولفيف مونو والداون تاون وعقائديّي أرجوان وأبجديّة، يفتخر الكثير بلبنانه الديمقراطيّ معدِّدًا أحزاب لبنان وتيّاراته السياسيّة متباهيًا بعديدها وسط محيطٍ من دكتاتوريّات الحزب الواحد. وإذ أجازف بإفساد فرحة التمايز هذه، أعلن:
كلّ هذا التعداد ولا خيارًا! فليس في لبنان إلاّ حزب واحد: الحزب الطائفيّ.
تمامًا كما العراق قبل الإحتلال والشام وتونس ومصر وليبيا والأردن والمغرب ودول الخليج، لبنان خاضعٌ خاصّةً منذ اتّفاق الطائف لدكتاتوريّة الحزب الواحد/الحاكم الواحد، مع فارق وحيد: أنّ تلك الدكتاتوريّات غبيّة فاسقة وأمّا دكتاتوريّة لبنان فذكيّة منافِقة! ولا يبدّل من هذه الحقيقة تعدّد الأسماء والألوان والمقاولين والمهرّجين والسفّاحين والمهرّجين السفّاحين. أمّا إلى أيّ فرع يتمّ إلحاق الأعضاء عند الإنتساب، فذلك من النظام الداخليّ للحزب الطائفيّ وممّا لا خيار لهم فيه: التقدّميّ الإشتراكيّ (كذا) للمولودين دروزًا، والوطنيّ الحرّ للمولودين مسيحيّين، والكتائب أو القوّات اللبنانيّة للمولودين موارنة خاصّة، وأمل أو فرع حزب الله للمولودين شيعة، وتيّار المستقبل للمولودين سنّة. وأمّا الإستثناءات، فاستثناءات نادرة تحتّمها المنافع القصيرة الأمد.
كلّ هذا التعداد ولا خيارًا!
فالطوائف المتحزّبة لا تقدّم بمنطقها وتخومها ودعواتها ومخاوفها واهتماماتها أكثر من مفرَدٍ بخيارٍ أحد: الحزب الطائفيّ؛ التنّين الواحد برؤوسه المتعدّدة!
ولبنان، وبعد غياب طوعيّ عن الإختراعات دام أكثر من 2500 سنة، قدّم اختراعه السّياسيّ إلى البشريّة: نظام ديكتاتوريّة الكونفدراليّة!
وها العراق، وبفضل وحيد القرن، على الخطى!
وليس خيارًا ما يطرحه بعض الطيّبين الصادقين، من باب اختراق الحصار، أن يكون للعلمانيّين حصّة في النظام الطائفيّ اللبنانيّ. بمعنى آخر، أن يتمّ التعامل مع العلمانيّين كالطائفة رقم 20، فيكون لهم ما لكلّ طائفة من حصص في المقاعد النيابيّة والوظائف الرسميّة ألخ. فليس هذا إلاّ تسليمًا بالنظام الدكتاتوريّ الطائفيّ وانخراطًا فيه، فاجتذاب العلمانيّين إلى حفلة المخادعة الطائفيّة ليس بحنكة سياسيّة بقدر ما هو خطأ بل خطيئة تُحوِّل العلمانيّين برمّتهم على المَديَين المتوسّط والبعيد إلى مجرّد طائفة فعليّة!
كلّ محاولة للموالفة بين الدّولة المدنيّة العصريّة من جهة والمجموعات الطائفيّة من جهة أخرى مجرّد تعاويذ. فإمّا دولة بأحزاب فكرٍ وبرامج وإذًا عمليّة ديمقراطيّة صحيحة أو طوائف متحزّبة وإذًا إقتتال دوريّ؛ وإمّا قانون مدنيّ إلزاميّ أو قوانين دكتاتوريّةِ الكونفدراليّة الطوائفيّة.
إمّا أو! ولا بين بين!
أمّا التعدّديّة الحزبيّة المرتجاة فهي التي تتنوّع رؤاها، أسسًا فلسفيّة وأنظمة قِيَميّة واتّجاهات علميّة ومنطلقات ثقافيّة ومفاهيم فنّيّة؛
وهي التي تتمايز نظريّاتُها الإجتماعيّة والإقتصاديّة والتاريخيّة، وأولويّاتُها السياسيّة ماليًّا وتربويًّا وبيئيًّا، ومؤسّساتها تنظيميًّا وآليّاتٍ داخليّة.
وهي التي يحيي صراعُها الفكريّ أحزابَها وأعضاءها ومواطنيّ الدولة برمّتهم ويبثّ الحركة والحيويّة في المؤسّسات والأفراد، وليست هي التي كلّما تباينت آراؤها خيّم الرماد؛
وهي التي تنشأ عن الأمّة، وليست هي التي بمواثيقها واتّفاقاتها تُفبرِك أمّة!
وهي التي بائتلاف بعضها تتشكّل حكومة، وليست هي التي بِائتلافها يتركّب وطن، فإن اختلفت تبدّد!
وهي التي فوزُ برنامج أحدِها الإجتماعيّ – الإقتصاديّ في تنافسٍ انتخابيّ لا يهدّد وجودَ مَن انهزم؛
وهي التي إنْ تَقدَّم بعضها على بعضها إنتاجيّةً وإنجازات، يتعرّى المتراجع ناقدًا ذاته جادًّا مبتكِرًا مطوِّرًا من أجل إعادة التقدُّم، وليست هي التي إن قلَّت دينوغرافيّتُها أو كثُرَت تُزبد وترغي وتُلبِس أنبياءَها ورسلَها وقدّيسيها ثيابًا مرقّطة!
التعدّديّة الحزبيّة المرتجاة هي التي، بتنوّع برامجها، تستحثّ خصائصَ الإنسان العاقلHomo Sapiens من تفكير وتحليل وتخطيط ومتابعة ومقارنة واختيار وانفتاح ومسالمة ومشاركة وتعرّف وتعلّم وانتقال، وليست هي في ما يعيده إلى غرائزه البدائيّة إنسانًا هَبيليًّاHomo Habilis محكومًا بالتوارث مطوَّقًا بالمخاوف موجَّهًا بأوامر الأمكَر والأعنف والأشرس والأوحش!
... وكلّ عديد الطوائف المتحزّبة المنعقد أقواها في اجتماع حزبيّ داخليّ حول طاولة مستديرة في ساحة النجمة، ولا خيارًا!
[1] Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer, University of Pennsylvania Press, Second Printing, 1990, p.p. 30-35
[2] القرآن، سورة المائدة، 56
[3] Jabez Delano Hammond, The History of Political Parties in the State of New York
[4] Fritjof Capra, The Web of Life, Anchor Books, p.p. 158-176
النمط Pattern وصِفته التكوين الذاتيّ Autopoiesis حيث التفاعل مع المحيط لا يحدّد التنظيم الذاتيّ وإنّما يحافظ عليه ويجدّده؛ البنية Structure وميزتها التبديديّةDissipative بمعنى اعتمادها على استهلاك ما هو ليس منها من أجل ديمومتها، من دون أن يعني انفتاحها بنيويًّا تدميرًا لانغلاقها تنظيميًّا؛ والعمليّة Process وشرطها المعرفة Cognition تاج الثالوث وفكرتها المركزيّة (قدّمها غريغوري باتسونGregory Bateson في الستّينات من القرن الماضي تزامنًا مع Santiago theory لهامبرتو ماتورانا Humberto Maturana وفاريلا Varela) هي في الإدراك (مثلاً إدراك النبات للنور والظلمة) الذي يشكّل الإدراك الناشئ عن الدماغ البشريّ أحد تجلّيّاته فقط.
[5] خليل حاوي، قصيدة الجسر
[6] فيليب برو، علم الإجتماع السّياسيّ، ترجمة محمّد عرب صاصيلا، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1998، ص 64-65
[7] الوحش حارس غابة الأرز في ملحمة جلجامش
[8] إشارة إلى كتاب عالم صوفي Sofi’s World لمؤلّفه جوستين غاردر Jostein Gaarder
- محاضرة نديم محسن حول "التعدّديّة الحزبيّة والطوائف"، في ورشة عمل "أزمة حقوق الإنسان بين المجموعات الطائفيّة وبناء الدّولة" التي نظّمَتها "جيل" بين 24 – 26 آذار 2006.
|